قصة قصيرة..
من وحي نافذتها
اندفع تنصفق الأبواب وراءه كأن الأرواح تطارده ، خرج مسرعاَ يسابق قطار الموت ، و لما وضع يده على الباب مزقت صرخة الحاجة يمينه غبش المليساء ، فتوقف و عاد أدراجه و مهجة الفاجعة تخنق حبال الكلمات بعبراتها التي أبت أن تنحدر ، دخل عرفته و غلق الباب ثم استند إليه يحاول السيطرة على أثار الصدمة ، وضع أصابعه المرعبة على وجهه و ارتسمت عليه علامات الحسرة .. تقدم إلى وسط الغرفة ، دقات الساعة يردها الصدى من العمق كأنها ضربات على الصناجة تعلن عن اقتراب نهايته ، استدار ، جلس على السرير ، نهض قائماَ ، وقف بجانب الشباك يشد بقوة على الستار ، يتواري ، مرتبكاَ يبحث عن وضعية ما ، عن شئ ما ، عن سبب ما ، عن حجة ما ، أي شئ يدافع به عن قائد الحواس ، كل ما بين يديه في هذه اللحظة واه ، لا يستطيع دفع شبهة واحدة ، و بات طريد ضميره ، متشرداَ بين طوايا النفس ، تفزعه صرخات الباكيات النائحات المتتالية ، وتلاحقه اللعنة في أشكال و صور مختلفة عبر تلا فيق و إلتواءات الواجس حيث تتوالى ضربات العتاب بقوة في عمق العاطفة ، و حرمت عليه البديهيات التساؤل ...في هزج هذا الاضطراب تسرب التفكير إلى مخازن الماضي و سحب بقوة شريط وقائع سُجل أهمها على الهامش ، فظهرت على تغره ابتسامة المغفلين ساخرة ، و فتحت كوة ينفذ منها شعاع النور الذي يحمل الصور التي أسقطها أثناء التركيب ، مُرتبة و جدها ، تروي الحقائق التي كانت تتألم في الخفاء ، يقرأ التعليق عليها الأنا
و يخطر ، كأنه يروي خواطر وجع التأبين ... إنها حليمة ، الحسناء التي كنت تصبح على ابتسامتها و تمسي ، أمام الشباك تذكرك بيرقاء في قفص ، يضيئ وجهها الصبوح وراء قضبان النافذة دروب الصبر ، إنها ذلك النموذج لانعكاس صورة تكامل الخلق و الخُلق ، لقبها أهل الحي بـ ( العاقلة ). كُنتَ تسميها أنت ( البحيرة الهادئة ) ليست كتوأمتها سليمة ، هذه الشعلة المرحة المتفتحة إلى درجة الجنون ، جمال و دلال ، توهم بسهولة المراس و توقع المعجبين كأنها السحر آخره سراب ، تميل إليها كثيراً تشدك عجائب المغامرات العاطفية و ذكريات الطفولة ، إنها صورة طبق الأصل لأمها الحاجة يمينة المنظفة التي استشهد زوجها في حرب 1967 ، في الحقيقة حليمة مهوانة و من طبعك ، تتقاسمان الكثير ، ولكن مرضها العضال ، ذلك السرطان الخبيث الذي منعها من مواصلة الدراسة و الزمها البيت لا يرحمها و أي إشارة أو إثارة يمكنها أن تحدث كارثة و تحطم تلك المشاعر النبيلة في تلك الروح الرقيقة ، تقرأ في نظراتها الكثير و لا تفهم شيئاَ ، كأنها عقدة قصة لأديب محنك ، اعتادت الجلوس في وقار و سكون ، تتأمل حركة الكائنات من النافذة المقابلة لغرفتك . تضع على كتفيها ( شالاَ ) أحمر ، من بعيد يحس المتأمل فيها بدفء الطبع ، كأنها لمسة في لوحة رائعة ، تسهر إلى ساعات متأخرة من الليل ، تطالع بنهم ، كانت تحرجك كثيراَ بنظراتها لما تقف على الرصيف تنتظر عودة سليمة التي أتعبتك بخطاب العيون المترددة ، هكذا كنت تفهمها ، تتودد إليك و لا تستريح ، تحارب فيك اليقين بحذر و تزرع في نفسك و هماَ غريباَ ، تدمر بالنكت الهادفة كل خطاب تشم فيه رائحة الهوى ، جمعت بأعجوبة روابط العلاقات التي كنت تراها متناقضة ، حتى أحسست و كأنك مجرد حقل لتجاربها النفسانية ، معلق دائماَ بين التفاؤل و اليأس ، و لم تجد سوى حدائق النثر تقطف الكتابات منها و تسبح في أعماق الأدبيات ، ترتوي من نبعها ، و تطفئ بنورها لهب الشوق تنتظر ركن الجريدة بلهف شديد لتقرأ لتلك التي تمضي قصائدها و خواطرها باسم ( الغاربة ) كانت تكتب عن الحياة برفق و تكتب عن الموت بكل عنف
و تحد ، تكتب عن المستقبل بجرأة التفاؤل و حيوية العزيمة ، جعلتك تجزم أنها سليمة كانت تعكس بصدق صور قلم الحي ، صنعت منك بهذا التحبير و البوح فارساَ عنيداَ و شغفك احتراقها على الصحائف.
- هذه الحاجة يمينة ، التي تحبك كثيراَ ، تلمح إليك دائماَ لعلك تفاتحها في خطبة سليمة ، كانت ترى فيك مثالية الشاب و نبراس المراس الطيب والمزاج الهادئ ، لواء الحياء والكرم والرزانة ، هكذا كانت تقول لك دائماُ ، ألا تذكر هذا ؟ ! ربما كنت تعكس صورة المرحوم ..؟ولكن مواقف سليمة منك ألزمتك الصمت ، تتظاهر في أكثر الأحيان بالغباء ، تنتظر براءة قلب سليمة من عوارض تتكهنها .
في صباح هذا اليوم قررت أن تفاتح الحاجة يمينة بكل شجاعة ،تشكوا إليها قساوة سليمة وتقلبات طبيعتها ، حينها أحسست أن المرأة إكتساها نوع من الاعتزاز والافتخار إلى درجة الغرور ، وانصرفت في كبرياء دون أن تقول لك كلمة واحدة... لعلها تأكدت من صون شرف العائلة ، وانتابك نوع من الإشمئزاز والخجل ، وبدا الندم يلتهم صدرك ، فدخلت إلى البيت في حالة انهزام نفسي رهيب ، وفي المساء كثرت الحركة في بيت الحاجة يمينة ،خرجت لمعرفة ما يجري عند الجارة وعلمت أن حليمة المسكينة تعاني سكرات الموت ، جمع غفير من الناس أمام الباب ، جلست بجانب السياج تنتظر بأسف شديد نهاية مخاض الموت التي ستنجب المصيبة لهذه العائلة الطيبة ، خرجت سليمة ، وقفت أمام الباب ، وأشارت إليك فأجبت مسرعاُ، وأحسست آنذاك أنها في أشد الحاجة إليك ، كأنها تريد منك أن تحضنها ، تضمها بكل قوة ، مدت إليك رسالة وهي تحاول أن تتحكم في شفة ترتعش تحت وطأة عبرات العيون الهمعة ، ثم دخلت ؛ وضعت الظرف في جيبك و أخذت مكانك وسط الجيران و أنت كلك تساؤلات ... لماذا انتظرت إلى اليوم ؟ ! هل أقنعتها أمها ؟ ! و هل..؟
و هل ..؟ بدأ طريق المستقبل يرتسم أمامك كله سعادة ، أنت الوحيد الذي يبتهج وجهك المنث بالسعادة ، في هذا الموقف الحزين ، لفتت ملامحك فضول الكثير ، تحاول عبثاَ إخفاء خفقات الهوى في جنانك ، و فجأة تبادرت أسئلة أخرى .. و مـن يـدري ، لعلها كتبت إليك لتبتعد عنها ، تلومك عن جرأتك في الكلام مع أمها في هذه الظروف ؛ الـوقت غيـر مناسب لرسائل الحب و الغرام ! !.. إنها الصفعة الأخرى التي لم تكن تنتظرها ، يجب أن تقرأ الرسالة ! . تسللت إلى غرفتك و فتحت الظرف ، كم ارتحت لما بدأت قراءتها ، كانت الابتسامة تغزو محياك إلى درجة انفجار المناتح ثم بدأت تختفي شيئاَ فشيئاَ حيث بدأت ترتسم القحفاء على الحروف و الكلمات .. و هي تقول لك : " أكتف بطيفك و أنت قريب ، ولما تبتعد يحس كل شئ في نفسي أنه غريب . و لا أملك لك من وجودي إلا الوجدان ترعى فيه على جراح التردد خوفاَ من آلام التضحية و الوفاء ، لم أعطك من جسدي شيئاَ تتمتع به لأنه هالك و خشيت أن تطرد لمسات الأنامل الهوى بعد الأفول ، دعني أروي عطشك في أحلامي و يقتلني الضمأ يقظة على الأرصفة الضائعة ، أتحسر على مسند شرفتي و أنا أرقب كل يوم غُروب شمسي ، دعني احترق في معبد الهوى فإني و هبت جسدي لحبك قرباناَ تصلك بركاته تحفظك من كل سوء لم تعرف حقيقة ما يجول في خاطري حتى لا أعكر صفو المياه في بحيرتك ، و يقتل الصبر حبك ، وبنيت له محراباَ تزوره دموعي كل ليلة ، أسكب فيه عبراتي و أبث فيه آهاتي و تنهداتي ، ولم تعرف عن حبي لك شيئاَ حتى لا تغادر الابتسامة ثغرك و لا يجد الحزن لك منفذاَ ، وأبقى أنا أعيش لذكراك أخلد في الروح التي تفارق في يوم من أيام حبك صورتي ... أحبك من بعيد و أنا راضية بك نصيباَ من العذاب يهد ما بقي في قلبي من دوافع العتاب ، ولن أقول لك إني أحبك حتى يغمرني السكون يوماَ
و أتوارى تحت التراب ، و يبقى عهدي لك خالداَ يتحدى لا يثني عزمه الدهر و لا القهر . " حليمة الغاربة.
أغلق الشباك و تراجع إلى الوراء جلس على مكتبه ، أصابه البحران من هول الزلزال الذي ابتلع الحب العفيف في جوف تلك القلعة المهيبة.
و في مساء يوم من الأيام عاد إلى البيت مبكراَ ، فوجد سليمة جالسة في نفس المكان الذي كانت تجلس فيه حليمة ، تحمل بين ذراعيها طفلة بهية الطلعة ، تدوي قهقهتها في البيت و تزرع الحياة ، فوقف يسألها فاحتجبت و سقطت بسمته في التراب ، دخل إلى غرفته رتب مكتبه و حمل القلم الذي جن بين أنامله يكتب بكل قوة عن الموت و حرارة الجفاء ، يتحدى بما توحيه إليه النافذة المقابلة من تراتيل الأشواق ينشرها بإمضاء ( الغارب ) يكتبها للعبرة و الذكرى و أشياء أخرى لا يدركها إلا أصحاب الفواجع ..
مختار سعيدي







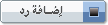







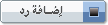
 (عرض الكل)
الاعضاء اللذين قامو بقراءة الموضوع : 8
(عرض الكل)
الاعضاء اللذين قامو بقراءة الموضوع : 8
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه